شطح الكائن الذي
لا يُجارى
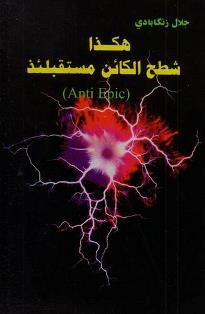
إبراهيم محمود
الشعر ليس أن تعيش الصدمة، وإنما أن تفعِّلها، وربما هذا ما سعى إليه
الشاعر العراقي الكردي متعدد المواهب جلال زنكبادي (1951)،
ومن خلال مجموعته الشعرية التي نشرت قبل عشرين سنة في مجلة القافلة
الفصلية الصادرة عن وزارة ثقافة إقليم كردستان العراق، وهي هكذا شطح
الكائن مستقبلئذ الصادرة عن مطبعة جامعة صلاح الدين، أربيل، إقليم
كردستان العراق.
أقول "مجموعة شعرية" رغم أنها نص شعري واحد أساسًا، وما يستدعيه هذا
"الواحد" من يقظة سابرة للإحاطة بما هو بانورامي متعدد الاتجاهات فيه،
وبالتالي فإن كل، أو أي إشارة إلى خاصية تجزيئية أو المقبوس باعتباره
مقطع قصيدة، ليس أكثر من إجراء، ولا يمكن تجاهل الجانب المحيطي له
لتبين صلاته المختلفة.
إن أول ما يلفت النظر هو البدء بـ "هكذا"، وما في هذه الكلمة من إحالة
على نوع من التشخيص أو التوصيف، وهو ما يعتمده الشاعر في طريقة الكتابة
المتكئة على بعثرة الكلمات لا جمهرتها، والتشديد على بعض منها،
والفراغات، واستحضار أسماء أعلام وعبارات تشير إليهم عبر ثقافات
مختلفة، حيث التاريخ مفتوح للشاعر ومقبوساته وتضميناته متعددة المرامي.
لاحقًا يكون الحراك الدلالي في شطح وما فيه من انزلاقات دلالية
ومكاشفة للمغيَّب، أي جنون الجنون أحيانًا، كما لو أن حلاجيًا من نوع
مغاير يريد البوح بكليته وتمثُّل الحلولية الذاتية بعين الذات، وربما
هو مزيج من الصراخ والأنين ونزف الروح، وتحديدًا آخر: صوب المستقبل،
وهو ما يقلب في مفهوم اللغة والزمان، إذ المفعَّل يؤم المستقبل، ولعل
الوارد في أسفل العنوان يشي بلائحة أخرى من الإحالات المرجعية في
الذاكرة الثقافية، أي
Anti-epic، أي ما يضاد
الملحمي، أو ما يطيح بسلطة السرد وما يكونه البطل الجامع لنفوس ورؤوس،
لأن المصاغ شعريًا يستهدف خرف الملحمي في تداخلات أزمنته.
لا أدلَّ من ذلك، من الترتيب المعكوس للأرقام، وحتى في نسج العبارات
والمآلات التي تهدر، إلى درجة "هدر الروح" بالكامل، تعبيرًا عن واقع
حال لم يعد في الوسع التستر عليه، كما لو أن الضد الملحمي ترجمان لغة
مقدَّمة هنا.
ومجاراة للشاعر يمكن البدء من النهاية أولاً، وما يقوله كختام مفترَض،
حيث يكون الخطاب الشعري موجهًا إلى ميديا الامبرطورية الكردية البائدة،
وما في ذلك من دلالة تحفر في تاريخ وجدانات من يجهل التاريخ وتحولاته:
لقد نفتنا الآلهة
غرباء مع أنفسنا
نجوس أزمنة التاريخ والمستقبل
دون كمنجات...
لعل الأغاني العصيبة تحسم مصائرنا
فرحماك لا تسوقيني يا ميديا أو لم نجد الكنوز في الجينات،
مذ ولدتُ
وعادت معي الشجرة إلى البذرة؟ فأنا ما ضللت دربي
وظللت أستحلفك ألا تتقهقري ولا
تسوقيني، فلولاكِ
من سيلملم أشلائي في ملاحم لا تنتهي التابوت
بطلها الأوحد؟
(ص131).
كأني به ينفض عما به ويكاشف ما به من عنف مؤصَّل جرَّاء علاقات
وانجراحات روح مأخوذة بعنف واقعها، وكون المشدَّد عليه تفعيل التفعيل
لمعنى موجَّه، إذ يكون الماضي مستعادًا، كما لو أن الجاري صورة طبق
الأصل، والخوف كل الخوف، هو أن لا يعود لهذا القائم بمتحوِّله الكردي
أي حضور، كما لو أن الشاعر عرَّافة المستقبل، لا بل وليَّ أمره.
في العودة إلى البداية ثمة زحام مآس ونواحات وتدافعها من الداخل، ثمة
الويل على أرض المعطيات الشعرية، حيث الإهداء لا يسر المعنيين
بالمجتمع، ولا الذين يمثِّلون الحقل الثقافي أو الأدبي وغيرهما فيه،
فثمة أكثر من خلل مسمى، وثمة أكثر من فساد في الذوق وفي الاعتبارات
النقدية وحالات التفضيل انطلاقًا من محسوبيات، واللغة تفصح عن ذلك: في
"الإهداء":
إلى الرواد الأفذاذ القلائل، الذين لم ينتبه أغلب الأدباء إلى أهمية
فتوحاتهم النظرية والتطبيقية، ومنهم، العلامة كمال أبو ديب، ثم إلى
المبدعين المغمورين رهن الإقصاء والتغييب والتهميش والتعتيم في كل
مكان، ومن ثم إلى الكتبة "النويقدين" الدائبين على تسطير وتدبيج العجب
العجاب عن نصوص فاترة ضحلة أو منفلتة مهلهلة النسيج...
ثمة رسالة واضحة في تفاصيلها، ولعلها تسمي فاعل الفساد الذوقي والأدبي
والنقدي وغيره، ومن خلال جانب تذوقي ورؤيوي حتى بالنسبة لناقده المنتقى
هنا.
وإذا كان الإهداء تقريعًا لمن يهمه الأمر، فإن في التعقيب ما يشير إلى
أهمية المقدَّم في النص الشعري الواحد والمتعدد الأصوات، ولهاث النفس
الشعري بحمَمياته، إن جاز التعبير، وما فيه من طرافة لا أظنها تضحك
أحدًا، وإنما تستوقفه، إزاء حالة لا تقتصر على الشاعر نفسها، بقدر ما
تشير إلى أكثر من حالة، وقد تقترب من الظاهرة في الفساد والإفساد
الأدبيين. في تعقيب، بمثابة ديباجة لا بد منها "رب يسر ولا تعسر" حيث
يشير إلى زمن قادم يكون توقف عند هذه المجموعة الشعرية حيث لم يبق سوى
على ثلاث نسخ في مكتبات محددة "كما هو الحديث في البحث عن تحقيقات
متعلقة بأعمال أدبية أو أدبية أو دينية قديمة" والمقارنة بينها، وتقديم
الأفضل والأسلم منها للقارئ ومن يكون تكون قراءته هي الأدق... خاصة وأن
المجموعة ضد الملحمية (ص8) ومن قبل المقربين المفترضين من الشاعر
شعوريًا أو تقديريًا عبر التالي:
يتفرد هذا النص بتكريس الشطح شعريًا، حيث أطلق الشاعر ساحر الكلمات
مارد الشطح من قمقمه فجاء فانتاستيك خوارقيًا ثرًا وحمَّال أوجه...
(ص9)
تكون ذات الشاعر هي رافعة الدعوى، روحه، الشاعر المضحَّى به، كما هي
البداية اللاحقة:
... وبرغم كثرة ما ألف السلف والخلف
هكذا بلغ الإملاءُ
في (هكذا شطح...) في صيف
سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف ربما...
(ص13)
ثمة التحديد التاريخي، ولكنه المتجه إلى المستقبل، حيث لا يجد الشاعر
بدًا من هذا الانتثار بكليته في أكثر من جهة، داميًا، أو مدمَّى، كما
هي أحول كلماته، كما هي قاطرات أوجاعه وتلك المازوخية اللافتة بعنف في
كل مشهد شعري لا تخطئه العين، حيث أقصى المازوخية دخول في الواقع
المتخَم بالسادية، وهو يؤنب اسمه، نفسه، مقامه، حقيقة ما هو عليه، وليس
استدعاء عشرات الأعلام والعبارات وتوظيفها في مجموعته إلا تعبيرًا عن
كونها شهود عيان على جريمة واقعة، وأي جريمة أكبر من جريمة تجاهل شاعر
يرى في المجتمع من أوجه انخساف وصدوع وتضارب قيم أكثر من غيره ويعاني
الكثير؟ لا أدل من ذلك، مثلاً حين يشبِّه نفسه بـ "بلاتيرو" ذي الدلالة
اللافتة طبعًا:
...
حسنًا ما المتوقع من
بلاتيرو كردي مثلي كمثلي؟
أنَّى أيمم ملحمتي المضادة، يثرثر قبري
فيمسرح أشلاءها الشامخة:
هيا يا ملحمتي الآثمة الشعثاء اعترفي
اشطحي...
(ص72)
"بلاتيرو" اسم حمار، وهو بطل كتاب بلاتيرو وأنا للشاعر الإسباني
خوان رامون خيمينيث (1881-1958) الحائز على جائزة نوبل للآداب (ص34).
إن حمرنة الذات، إن جاز التأليف، إفصاح عن الصبر النافد له، عن ملحمية
أخرى لهذا الكائن، بقدر ما يكون نسفًا للسائد أو القائم على صعيد
المرسَل والمتلقى والمروَّج له شعريًا، بقدر ما يكون التجنيس
"الحيواني" كرديًا انضمامًا إلى عالم أوسع، وتبليغًا بذلك الدفق من
الشعورات التي تلهم الآخر وتعلِمه بالنظير الممثَّل في الشاعر هنا.
ولعل الشاعر الداخل في لعبة اللغة والرهان على من سيرث الآتي، كما هو
التنبيه إلى ضرورة التلفت إلى خاصية القول الشعرية، لا ينفك ينتقل من
تفجير مشهد شعري تلو آخر، وكأني به يوقظ مدينته على دوِّيها، وهو دوي
عافية يروم ما هو أفضل، إلى درجة الدخول في تكرار يترجم مدى احتشاده
بالحنق أو القهر أو السخط، ليكون التالي خاصته، أي ليكون المعلَن عنه
إعلامًا بالذين ينعمون بفساد مستشر بما يشير إليه، بصفته ممثَّل الآتي،
وبنوع من الإنذار الصاعق:
... سيضبط
شعراء القرون الغابرون أوقاتهم
على ساعتك مثلما فعل الشعراء القادمون
لكنك ما زلت ضيقة يا
ملحمتي المضادة...
(ص36)
أيها الشوك قريني
زدني عشقًا للوردة رهينة العيون الشرسة.
لعلي أظل أتحدى قدري؟!
(ص47)
التحرك، السباحة، التوجه عكس التيار، ليس غواية الشاعر ليلفت النظر،
إنما صنعته التي يجب أن يخلص له، ولو أنه فيما يحشده من كلمات أشبه
بجيوش جرارة، ليصعِّد بالمواجهة حبًا في الأفضل مجتمعيًا، ولما كان
عنوانه ذاك.
إن الأقرب إليه في هديره النفسي هو صاحب أناشيد مالدورور
الفرنسي لوتريامون (1846-1870)، وتاليًا سلسلة الساخطين: بودلير، إلياس
أبو شبكة، حسين مردان، إنما أيضًا يظهر أن لنيتشه زخمًا دلاليًا في متن
قوله بحدته... إلخ.
إنه بحث عن الروح المهدورة، في مواجهة مجتمع يتم تعريضه للخلل من
الداخل، حيث لا يبدو أن الكلمات تستجيب له كما ينبغي، إزاء هذه
التراكمات من حالات السخط والتهميش والمطاردة المستقرأة.
أعتقد أن ما أورده جلال في نهاية مجموعته الشعرية في وحدتها النصية
وتداعياتها، من نقاط لها خاصية التعريف به، تضعنا في مواجهة هذا المنحى
الكارثي المتعلق بموقعه والتعتيم عليه، كما لو أن التعريف إشهار
بالجاري وشاهد عيان على المثبَت شعرًا:
الشاعر جلال حسين محمد زنكبادي لرستاني مواليد 1 ك1، كردستان العراق
1951، شاعر، مترجم وباحث عراقي باللغتين العربية والكردية، ويترجم
بينهما، عن الفارسية، الانكليزية، الاسبانية، التركية والتركية
الآذرية...
ضمنًا: تثقيف ذاتي موسوعي. لم يحظ طوال مشواره الثقافي – إلى حد الآن -
بأية إيفادات داخلية أو خارجية من قبل الأجهزة أو المؤسسات العراقية
ومنها الكردستانية... ولم يلفت لعطائه شبه الموسوعي "الشعري والترجمي
والبحثي: إلا القليل من الأدباء والنقاد والإعلاميين المنصفين...
(ص142).
*** *** ***
القدس العربي،
21 أكتوبر 2013