شجاعة الحقيقة: بين التباسات الجنس واضطرابات الجندر
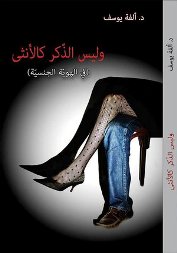
العادل خضر
لعلَّ
ما يميِّز أزمنة الحداثة، وما بعد الحداثة، منذ منتصف القرن العشرين
إلى اليوم، هو أنَّ اقتصاد العبارة ومجالات توزيعها قد تغيَّر على نحو
جذريٍّ في المجتمعات الحديثة منذ اندلاع الحركات النسوية وثورات "من لا
صوت لهم" و"لا نصيب لهم" في الفضاء العمومي السياسي. فبعد أن كان قطب
الكلام الوحيد ومركزه يحتكره الرَّجل "الفحل" وينجزه في خطاب وسمه
لاكان بـ "خطاب السَّيِّد" الذي يجد أسباب وجوده في اعتراف العبيد،
والقُصَّر ممَّن يبحثون عن سيِّد يعتني بقُصُورهم
minorité
الأبدي، صارت العبارة منذ عصر الأنوار موزَّعة على
أطراف جديدة، ووجوه غريبة تبعث على القلق لأنها تمتلك لغة خاصَّة بها
تأبى أن تختزل في خطاب العلماء، أو أن تترجم في لغة أخرى غير لغتها
المتوحِّشة.
من الشَّيِّق أن يبدأ كتاب ألفة يوسف وليس الذكر كالأنثى منذ
المقدِّمة بالإنصات إلى صوت امرأة بلا مجد ولا اسم ممَّن تعوَّدنا أن
لا نُوليهم سماعنا، "هممتُ بالانصراف لكنها ترجَّتني أن أستمع على
الأقلِّ إليها"، بل دون مغامرة الإنصات ما كان لهذا الكتاب أن تتوفَّر
له بعض أسباب وجوده. فقديمًا كان السَّماع سمة الإذعان، إذ لا يُسمع
إلاَّ من "أسمعت كلماته من به صمم" من فرسان الكلام وملاَّك الحقيقة.
أمَّا حديثًا فقد جَدَّ انقلاب في إستراتيجيات السَّماع منذ نجح فرويد
في سماع صوت الهيستيريا، وأفلح فوكو في الإصغاء إلى لغة الجنون، وصرنا
من ثمَّة نفهم لغة الصَّمت. صار أولئك الذين كانوا لا يتكلَّمون
يُسمعون وإن صمتوا، ويُقرأ لهم حساب إن تكلَّموا، وصار العالم المفكِّر
والكاتب المتأمِّل يبحث في كلماتهم عن شفرة بؤسهم. وليس بؤس البؤساء
نابعًا من القهر اليومي الذي يمارس على الأجساد بفضل تقنيات الحكم
الجديدة التي حوَّلتهم بفضل البيوسياسة
biopolitique
إلى كائنات "زائدة على الحاجة"
des
superflus،
وإنما بسبب عجزهم المأساوي عن فهم ما يحصل لهم.
من انعدام أسباب الفهم تبدأ قصة هذا الكتاب. تصوغ امرأة ما (رمز إليها
بحرف "أ") حيرتها في خطاب بوح تقول:
أريد أن أسألك هل أنا طبيعية؟ فقد أقمت عديد العلاقات الجنسية مع رجال
ومع نساء لمدَّة سنوات طوال. ولا أشعر أني ارتكبت خطأ أو ذنبًا ومع ذلك
فإني لا أجرؤ على الحديث في هذا إلاَّ مع بعض من صديقاتي المقرَّبات.
وكثيرًا ما أرى في عيون بعضهنَّ اتهامًا خفيًا، وكثيرًا ما كان بعضهن
يصرِّحن بذلك الاتهام فيصفنني بالعاهرة والشاذَّة والفاسدة إلخ... أريد
أن أعرف هل أنا فعلاً كذلك؟ ولماذا كنت أشعر أنَّ كل علاقاتي عادية؟
لا تفهم المرأة التي تتكلَّم عن مغامراتها الجنسية سرَّ عدم شعورها
بالإثم، كأنَّ سلوك المرأة الجنسي لا يمكن أن يغدو معقولاً ومفهومًا
إلا في إطار الخطيئة أو وعي يُدين ويُحاكم ويُؤثِّم ما [لا] إثم فيه.
فحين ينتفي هذا الإحساس وتزول الخطيئة التي تجعل من ممارسة الجنس أمرًا
محرَّمًا خارج المؤسَّسات التي تبيحه كالزواج بأنواعه المتكاثرة اليوم،
ينقلب غياب الإحساس بالإثم إلى قلق. إنَّ المرأة التي لا تشكو من فتور
"أنا(ها) الأعلى" إنما تشكو من اضطراب صورتها حين لم تجد في مرآة الآخر
ما يشبهها أو من يشبهها. فحين لا نجد الشَّبيه أو شبيهنا يحدث هذا
الاضطراب في النوع أو هذا الاضطراب الجندري ما أن نعتقد أنَّنا صرنا
"بائنات"
monstres،
قد فارقنا سلالتنا وصرنا كائنات بهويات جنسية مختلفة. هذه الهويات التي
يعلِّمنا التّاريخ أنها طالما كانت موجودة، وتركت آثارها المكبوتة في
مستودع اللغة وبعض الكلمات، قد انفجرت لمَّا تغيَّر اقتصاد العبارة
واستراتيجيات السَّماع. فأضحت الحدود "المانعة" بين الذَّكر الأنثى
حدودًا "جامعة"، كأننا أمام ثورة جنسانيَّات
sexualités
جديدة تبحث عن هويَّتها الثقافية في معاجم اللغة
وأركيولوجيات الخطاب.
ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب أمران:
-
أوَّلهما أنَّ حيرة المرأة "أ"، لم يكن بسبب فساد أخلاقها
immoralité
بل من جرَّاء لا أخلاقيتها
ammoralité.
وبين العبارتين فرق عظيم. فعندما ترتبط الممارسة الجنسية بأخلاقية
تستمدُّ مفرداتها من السجل الديني الفقهي، فإنَّ كلَّ ما يخرج عن
منظومة الحلال يصبح حرامًا، وكلُّ علاقة جنسية خارج الإطار الذي حدَّده
الشَّارع تصبح غير شرعية ويعاقبها القانون أو الشَّرع بأشكال من العقاب
متفاوتة الشِّدَّة والعنف. وأشدُّ من العقاب تلك النظرة المحاكمة
المؤثِّمة التي تزجُّ بالفعل الجنسي في دائرة الخطيئة والإثم والعار.
فيصبح كلُّ من اقترب من امرأة متزوِّجة أو غير متزوِّجة من "الزُّناة"
أو "زير نساء" أو فاسدًا، وكلُّ من صاحبت من النساء رجلاً غير زوجها
موصوفة بألفاظ كـ"العاهرة والشاذَّة والفاسدة". وتزداد النظرة قسوة
وصرامة في إطار الجنسانية المثلية
homosexualité
التي يمارس عليها ضرب من العزل، بحيث صار كلُّ
"مِثْلِيٍّ"
homosexuel
من هذا الجنس أو ذاك يصنَّف في فئة اللاأسوياء
anormaux
من الذين شذُّوا عن المنوال السَّويِّ الذي تحدِّده
أخلاقيات الجنسانية المغايرة
hétérosexualité.
كلُّ حيرة المرأة نابعة من كونها لا تضع سلوكها الجنسي في هذا الإطار
غير الأخلاقي
immoral
الذي يبيح محاكمتها وتأثيمها، لأنَّها بكلِّ بساطة
تنظر إلى الجنس بوصفه ممارسة ومعرفة في إطار مختلف لاأخلاقي
ammoral
محض. وهذا الانقلاب
perversion
في طريقة النظر إلى الفعل الجنسيِّ قد تأتَّى لها
بسبب انقلاب في سلوكها الجنسي قد استند إلى "معرفة بالفعل"
un savoir-faire،
وارتبط بمعرفة مباشرة بطبيعة الأشياء، أي بسلوك جنسي متَّصل بحقيقته
الخالصة، وهي "لاأخلاقية" الجنس و"لاأخلاقية" السلوك الجنسي.
-
ثانيهما أنَّ المترتِّب على هذا الانقلاب هو طبيعة هذه المعرفة
اللاأخلاقية. فهي تبيِّن أنَّ الأخلاق، بما هي خطاب أخلاق، لا تتوفَّر
أسباب وجوده إلا إذا ارتبط بالجنس. فأكثر الخطابات أخلاقيةً وتشبُّثًا
بالأخلاق هي التي يفضي فيها الحديث عن الجنس إلى الأخلاق حتى وإن كان
الحديث عن الجنس محكومًا بمنطق الانتهاك وتجاوز كلِّ الحدود، على غرار
المركيز دو ساد. يكتب لاكان اسم "ساد" بطريقتين، تارة باحترام دالِّ
الاسم
Sade،
وطورًا بكتابته على نحو كلاسيكي
çade،
ليبيِّن أنَّ كلَّ أخلاقية تقف في مستوى
le ça
الهو الذي يوصف أحيانًا بكونه مزبلة اللاشعور.
وعندما تقف هذه الخطابات عند هذا المستوى فيعني ذلك أنَّ معرفة الأخلاق
بالجنس محدودة وسبيلها إليه قصير. وهذه المعرفة القاصرة والمقصِّرة هي
التي جعلت هذه المرأة في حيرة من أمرها، لأنَّ ما تعرفه عن الجنس يفوق
بكثير المعرفة الأخلاقية الفقيرة الشائعة عند عموم الناس.
من هذه المعرفة الفقيرة المتغلغلة في الضمائر والحسِّ المشترك تكوَّن
نظام خطاب استمرَّ طويلاً، واستخدم في قمع الجنس بإفقار معرفة الناس
ومنع الحديث عن الجنس بشتَّى السبل الممكنة. فتشكَّلت بحكم هذا العنف
معرفة مسطَّحة منحرفة أو مشوَّهة عن الجنس جعلت ممارسته اليومية محفوفة
بضروب من الأوهام والمخاوف وسوء الفهم، ترجمتها "اللغة اليومية"، "لغة
الشارع"
la rue
وهي لغة لا تتكلَّم "لغة الشارع"
le
législateur،
تُنطق تارة سرًّا وهمسًا، وطورًا تنفجر على نحو غاضب فاضح.
من هذه اللغة اليومية، التي تؤثث حياتنا كلَّ يوم، وتغذِّي لغتنا
الجنسية، تنفلت من حين لآخر كلمات "نابية"، وشتائم متهتِّكة، وأحاديث
سرِّيَّة تترجم قلقًا جنسيًا عميقًا من جرَّاء الطَّوق الأخلاقي الذي
يحاصر هذه اللغة، فيجعلنا نشعر إزاءها بالحرج، أو الخجل، أو الخزي
والعار في أقصى الأحوال، من هذه اللغة المشحونة الملغَّمة انطلق مشروع
ألفة يوسف. وهو مشروع احتاج إلى إجراءين:
1.
أن تجعل من هذه اللغة اليومية الحقيرة المبتذلة موضوعًا نبيلاً جديرًا
بالدرس الأكاديمي الرصين، فتنصت إلى ما تهمس به وما تجهر، إنصاتًا
يستمدُّ من التحليل النفسي تقنياته، ومن فلسفة اللغة مفرداته، بغية
تفكيكها، أي تخليصها من الخطاب الأخلاقي، والزَّج بها في إطار جديد
يقوم على إيطيقا الفهم لا على أخلاقيات الإدانة والمحاكمات.
2.
أن تنقل المعرفة الجنسية التي كانت تتحكَّم فيها مؤسَّسات الدِّين
والقانون والسياسة والأخلاق، ويمثِّلها جميعًا "خطاب السيد" الذي يهب
لهذه المعرفة حقيقتها، إلى خطابات أخرى تكشف حقيقة الجنس وتضيئها
بأنوار جديدة، كخطاب المرأة اللاأخلاقي الذي يقدِّم معرفة جديدة عن
الجنس احتاج إلى إنصات المؤلِّفة وعبارتها حتَّى يكتسب وجاهته وتُكتشف
"شجاعة الحقيقة" فيه، فكان خطابها مراوحة بين خطابين، "خطاب الجامعي"
لأنَّه اتَّخذ من المقال أو المقالة شكله الأكاديمي الاستكشافي
المتسائل، و"خطاب المحلِّل" الذي ينصت إلى كلام المرأة ليكشف ما في
أقوالها من معرفة تجهل ما فيها من طرافة وثراء واختلاف.
توزِّع المؤلِّفة مادَّة كتابها إلى بابين: باب للرجل وآخر للمرأة.
وراء هذا التَّوزيع منطق اختلاف حادٍّ بين الرجل والمرأة تختزله عبارة
العنوان "ليس الذَّكر كالأنثى". وبين عنوان الكتاب وعنواني البابين
مفارقة تحملنا على أن نتساءل: هل المؤلِّفة تتحدَّث عن النوع
(رجل/امرأة) أم عن الجنس (ذكر/أنثى)؟ وهل نظام الخطاب المتعلِّق بالنوع
هو ذاته نظام الخطاب المتعلِّق بالجنس؟ وإذا كان عنوان الكتاب الفرعي
"في الهوية الجنسية" فهل هي تطابق "الهوية الجندرية" أو "هويَّة
النوع"؟ هل تختلف عنها بحيث تكون هوية الجنس غير هوية النوع؟ هل هي جزء
لا يتجزَّأ منها لا تنبني إلا بها بحيث تكون هويَّة الجنس بمنزلة
المدلول لا يمكن الإفصاح عنها إلا بلغة الرَّجل والمرأة اليومية، تلك
اللغة التي تشيِّد يوميًا هويتهما الجندرية على نحو اجتماعي ثقافي
رمزي؟ ثم ألا يترجم هذا التقسيم المثالي (أنثى [جنس] = امرأة [نوع] /
ذكر [جنس] = رجل [نوع]) رؤية الجنسانية المغايرة المتصنِّعة التي
تروِّج لانسجام مفتعل وهميٍّ يجعل النوع منحدرًا بالضرورة من الجنس؟
لا تعتني المؤلِّفة بالحالات التي تترجم فوضى الأجساد حين لا يعكس كلُّ
جنس جندره، ولا يعبِّر كلُّ نوع عن جنسه، أي الحالات التي يفقد فيها
أنموذج "الانعكاس المثالي" بين النوع والجنس انسجامه الذي تنهض عليه
الجنسانية المغايرة، لأنها بنت تصوُّرها العامِّ للهوية الجنسية على
منوال العلامة اللغويّة السوسيرية. فهي منذ المقدِّمة تحدِّد العلاقة
بين هويَّة الجنس وهويَّة الجندر بقولها:
يمكن أن نقول إنَّ الجنسيَّ والثقافي في هذا الكتاب هما دوالٌّ على
الهوية الجنسية وإنَّ القراءة التحليلية النفسية هي مدلول الهوية
الجنسية.
ورغم أنَّنا نحترز من هذه الصياغة التي تهيكل "الهوية الجنسية" نظريًا
بمنطق العلامة اللغوية على نحو يجعل الهوية الجنسية بلا موقع واضح داخل
بنية العلامة، إذ نجدها تارة في موضع الدَّالِّ، وطورًا في موضع
المدلول، فإنَّ فصول الكتاب وفقراته الكثيرة تؤكِّد أنَّ تحاليل
المؤلِّفة كانت من جهة الإجراء محكومة بمنوال آخر للعلامة، أقرب إلى
بيرس
Charles. S Peirce
منه إلى دي سوسير
Ferdinand de Saussure،
وأقرب إلى السيميائيات منه إلى اللسانيات. فالمـتأمِّل في طريقة بناء
الكتاب لا يجد عنتًا في إعادة هيكلة مادَّته وفق تصوُّر بيرس للعلامة.
من ذلك أنَّه يمكن أن ننزِّل هويَّة الجنس في محلِّ الموضوع
objet
من العلامة البيرسية، وما "اللغة اليومية" سوى
ممثِّل
representamen،
أو دالٍّ تهيَّأ لتمثيل تلك الهوية بما يحدِّد هوية النوع لدى الرجل أو
المرأة. أمَّا "القراءة التحليلية النفسيّة" وغيرها من القراءات
الممكنة (كالقراءات النسوية، والدراسات الثقافية
Cutural
Studies،
والجموع الجنسية
multitude sexuelle
في نظرية الكوير
Queer...)
فهي بدورها دوالُّ مفسّرات أو مؤوّلات
interprétant
منفتحة (لانهائية نظريًا) لتلك اللغة التي تفضح
باضطرابها قلقها المأزوم في تمثيل الهوية الجنسية.
هذا القلق نابع في نظرنا من استحالة تطابق دوالِّ الهوية الجندرية
بموضوعها، وهو "الهوية الجنسية". فذكورة الرجل وأنوثة المرأة ليست من
تحصيل الحاصل. فهي ليست معطى ما قبليَّ، ولا أساس أنطولوجيَّ لها،
فهوية النوع تصنع (كما يصنع الجنس الذي لم يعد هبة من هبات الطبيعة)
دون انقطاع، ولا وجود لها خارج الأعمال التي تنجزها. يكفي أن نتتبَّع
عناوين الفقرات التي تألَّف منها الكتاب حتى ندرك أنَّ اللغة اليومية
التي تناولتها المؤلِّفة بالتحليل إنما هي طريقة من الطرق الممكنة في
صناعة الجندر. وليست هذه اللغة سوى أعمال لغوية، من جنس الأعمال
الإنجازية التي تحدَّث عنها بعض الفلاسفة التحليليين على غرار أوستين
Austin
وسورل
Searle،
إلا أنَّها تمارس نجاعتها الرمزية على سطح الجسد بواسطة لعبة الحضور
والغياب (كحضور علامات الذكورة أو الأنوثة وغيابها) لتشييد "الجسد
المجندر"
le
corps genré
من خلال سلسلة من الإقصاءات والإنكارات ذات دلالة
بالغة.
تتحكَّم في هذه اللعبة بعض القواعد الأساسية في إنشاء الدوالِّ
الممثِّلة للهوية الجنسية. فإذا سلَّمنا بأنَّ الذكورة والأنوثة بناء
رمزيٌّ ثقافي اجتماعي تترجمه اللغة اليومية بمفرداتها وأعمالها
الإنجازية المختلفة فإنَّ هذا البناء محكوم بمنطق خاصٍّ يدور على لعبة
حضور العلامة أو غيابها. ويتحقَّق هذا الحضور والغياب عند الرجل بأعمال
إنجازية من أبرزها "عمل الإثبات" كـ"إثبات العضو الذكري جنسيًا
وثقافيًا" بما هو شرط للانتماء إلى مجموعة الذكور، أو "عمل النَّفي"
عبر التهديد بالخصاء الخيالي ومن صوره البارزة قطع العضو الذكري أو
العجز عن الانتصاب، أو إقصاء الأنثويِّ... أمَّا عند المرأة فتدور لعبة
الحضور والغياب على "الشَّوق إلى العضو الذكري جنسيًا ثقافيًا" هذا إذا
فهمنا أنَّ الشوق هو دائمًا شوق إلى مستحيل، وليس هذا المستحيل سوى هذا
الغائب الذي تحاول المرأة امتلاكه بنكرانه، أو بوسم الافتقار إليه
بمتعة أخرى هي متعة أنثوية مخالفة للمتعة القضيبية، لأنها صامتة لا
تكون إلاَّ خارج الدَّالِّ، لا يعبَّر عنها بالكلام ولا تنشئها اللغة.
فهي "محض فكرة وإنتاج خياليٍّ. فمجرَّد وجودها خارج اللغة يزجُّ بها في
سجل الاعتقاد، ويجعلها متعة زائدة لا يمكن تحديدها أو التفكير في إمكان
وجودها إلا انطلاقًا من الخصاء". فثالوث الخصاء والشوق والمتعة يؤكِّد
في النهاية أن لا "هوية جنسية" خارج الدَّالِّ الذي يعيد تمثيلها
وتأويلها وتوزيعها. فإن كان عنوان الكتاب يردِّد بعبارته الحاسمة "ليس
الذكر كالأنثى" فإنه في الواقع يترجم سلطة القضيب بما هو دالٌّ تتحدَّد
بامتلاكه أو بعدم امتلاكه هوية الذكر والأنثى.
تنهي ألفة يوسف كتابها بخاتمة موجزة متعجِّلة تطرح فيها سؤال البدء.
وهو لا محالة سؤال ديني فلسفي تحليلي نفسي أيضًا. "في البدء كان
الكلمة" هكذا يبدأ الكتاب المقدَّس. "في البدء كانت الأم" هكذا ينتهي
كتاب ألفة يوسف. وسواء كان البدء "كلمة" أو "أمًّا" فإنَّ الفلسفة
الحديثة تعلِّمنا أنَّه لا يوجد بدء مطلق، كلُّ بدء لا يكون إلا بعودة
أو بعود كما تقول العرب. وقد جاء في اللسان أنَّ "العود هو ثاني
البدء". وحينما نعود إلى ما نتوهَّمه بداية يكون البدء الأول قد تغيَّر
كلَّما يمَّمنا عائدين إليه. هذا العود الذي يغيِّر كلَّ البدايات قد
يتَّخذ شكل عيد إن كان موسميًا وقد يتَّخذ شكل ثورة
révolution
(بمعناها الفلكي) حين يعود باكتمال دورة النجوم، وقد يكون عيادة أو
زيارة نجدِّد فيها طرح الأسئلة المنسية مثل "سؤال الوجود الجوهري: "من
أنا؟" و"ماذا أمثِّل بالنسبة إلى الآخر؟"" أو "سؤال المعنى الأصلي".
ورغم النَّغمة الغامضة التي ينتهي بها الكتاب حين تجزم المؤلِّفة بعد
ترحال طويل:
نعم، ليس الذكر كالأنثى، لكن كليهما مسجون بين أقطاب السماوات والأرض
لا ينفذ منها إلاَّ بسلطان.
فإنَّ قراءة الكتاب يمكن أن تثير في كلِّ فقرة القلق، وتصدمنا، وتحرج
بتوقِّحها كثيرًا عفَّة القارئ الرسمية، ولكنها في كلِّ الأحوال تظل
قراءة ممتعة صعبة لأنَّ المعارف التي يحويها الكتاب ليست من الشائع
المبتذل، وقد اقتضى ذلك أن يكون أسلوب كتابتها على وضوحه جارحًا دائمًا
لأنَّ بعض الحقائق التي تقول الحقَّ
le
dire-vrai
على نحو صريح تتطلَّب كما علَّمنا ميشال فوكو في
آخر دروسه أن نتحلَّى بأخلاقيات ذاك الذي يفكِّر بصوت مسموع، فلا تأخذه
في الحقِّ لومة لائم، حين يلتزم بالحقيقة ويجازف من أجلها.
*** *** ***
الأوان، السبت 1 شباط (فبراير) 2014